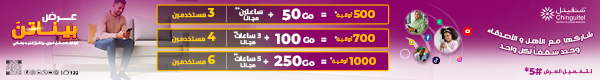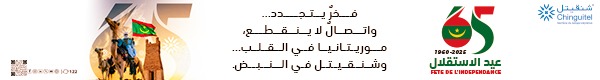أسفرت الأزمة الخليجية الحالية عن خيبة أمل عميقة في فقهاء ودعاة مشاهير انحازوا لمواقف حكومات القطيعة، رغم إدراكهم -وإدراك كل مسلم ذي فطرة سليمة وضمير حيٍّ- أن تلك المواقف مناقضة للمعلوم من الدين بالضرورة، لأنها تضمنت قطع الأرحام، ومعاداة أهل الإسلام، وموالاة أعدائهم من الصهاينة، وحصار شعب مسلم شقيق في رمضان.
كما تضمنت الإصرار على انتهاج سياسات جائرة، منها بذْل المال الوافر، والدعاية الإعلامية، والغطاء الدبلوماسي، نصرةً للظالمين، وعونا لهم على استباحة دماء الأحرار الأبرار بغير حق، وسَجْنهم وتعذيبهم، وتشريدهم من أوطانهم، لمجرد أنهم طالبوا بالحرية والعدل في بلدانهم.
وزاد من وقْع هذه المواقف المريبة وألمِها في النفوس المؤمنة أن تصْدُر من علماء ودعاة ينتمون إلى بلاد الحرمين الشريفين، التي تهفو إليها قلوب المسلمين في كل أرجاء العالم استمداداً للنور والهداية، ويَفترِض المسلمون في علمائها ودعاتها أن يكونوا قدوة في التعبير عن أحكام الإسلام وقيَمه، بعيداً عن العصبيات الوطنية، والمحاباة السلطانية. وقد ذكّرني هذا الواقع الأليم بقول الشاعر الفيلسوف محمد إقبال في ديوانه "جناح جبريل":
ذهب الدراويشُ الذين عهدْتُهم ** لا يعبؤون بصــــارم ومهنَّـــــدِ
وبقيتُ في حَرَمٍ يتاجر شيــخُـه ** بوشاح فاطمةٍ ومصحف أحمدِ
ويبدو لي أن السبب في كل هذا السقوط هو الانسلاخ من القيم السياسية الإسلامية، خصوصا مبدأ المساواة بين الحاكم والمحكوم أمام الشرع، ومبدأ "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". فقد أوجب الله تعالى على الحاكم أداء الأمانة والحكم بالعدل، وأوجب على المحكوم طاعة السلطة الشرعية في المعروف، ووضعَ مبدأً يحتكم إليه الطرفان وقت الخلاف، وهو الرد إلى الله والرسول، أي الاحتكام إلى القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدل الاحتكام إلى منطق القوة وقانون الغاب.
فالمبادئ الأربعة المتضمنة في آيتيْ الأمراء (وهي أداء الأمانة، والحكم بالعدل، وطاعة السلطة الشرعية، والرد إلى الله والرسول) مبادئ مترابطة يعضِّد بعضها بعضا، ولذلك وردت في سياق واحد هو قوله تعالى موجِّها الخطاب للأمراء: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعمَّا يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا" (سورة النساء، 59)، ثم مخاطبا الرعية في الآية التالية: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا" (سورة النساء، 60).
قال الإمام الشافعي مفسِّرا قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول: "فإن تنازعتم: يعني -والله أعلم- هم وأمراؤهم الذين أُمِروا بطاعتهم. فرُدُّوه إلى الله والرسول: يعني -والله أعلم- إلى ما قال الله والرسول". (الشافعي، الرسالة، 79). وقال الزمخشري في تفسيرها: "فإن اختلفتم أنتم وأولو الأمر منكم في شيء من أمور الدين، فردوه إلى الله ورسوله، أي: ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة". (الزمخشري، الكشاف، 1/524). وقد ورد الأمر بالرد إلى الله والرسول بعد الأمر بالطاعة مباشرة، إشارةً إلى أن حدود الطاعة كثيرا ما تكون مصدر تنازع بين الحاكم والمحكوم، وأن حل هذا التنازع يكون بالاحتكام إلى القرآن والسنة.
ولمبدأ الرد إلى الله والرسول مدلولان: مدلول مرجعي وهو أن الكتاب والسنة هما المصدر في حل التنازع، ومدلول دستوري وهو المساواة بين الحاكم والمحكوم أمام القانون، وهو مرادف لمفاهيم "حكم القانون" و"المساواة أمام القانون" في الاصطلاح الدستوري المعاصر. أما المدلول الأول فواضح في الثقافة الإسلامية، وأما الثاني فأصابه الكثير من الغبش على مرِّ القرون، وهو ما نركز عليه هنا.
لقد جاء الإسلام بالمساواة بين الحاكم والمحكوم أمام القانون بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الفكر السياسي البشري، حتى إن النبي صلى الله عليه عرَض على أحد أصحابه أن يقتصَّ منه، حين آلمه بوخز سهم بيده على سبيل الخطأ (ابن هشام، السيرة النبوية 1/626).
واستلهم عمر بن الخطاب هذا الهدْي النبوي فأقاد من نفسه، واستنكر ضرب السلطة للناس بغير وجه حق، بل اعتبر ذلك تعدِّياً على "حِمى الله" عز وجل: "عن حبيب بن صهبان قال: سمعت عمر يقول: ظُهُور المسلمين حِمَى الله لا تَحِلُّ لأحد، إلا أن يُخرجها حدٌّ. قال: ولقد رأيتُ بياض إبطه قائماً يُقِيد من نفسه". (عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، 9/464). وقد أورد المحدِّث عبد الرزاق الصنعاني هذا الأثر وآثاراً أخرى في الموضوع تحت عنوانيْن معبِّريْن وهما: "باب القود من السلطان." و"باب قود النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه". (عبد الرزاق، المصنف، 9/462، 465).
وقد أحسن إمام الحرمين (قديماً) أبو المعالي الجويني (419-478 هـ) التعبير عن المساواة بين الحاكم والمحكوم أمام القانون في الإسلام، فقال: "فالمسلمون هم المخاطَبون، والإمام في التزام أحكام الإسلام كواحدٍ من الأنام، ولكنه مستناب في تنفيذ الأحكام". (الجويني، غياث الأمم، 276).
وهذا المبدأ الإسلامي -القاضي بالمساواة بين الحاكم والمحكوم أمام القانون- خروجٌ على تقاليد الملكيات العتيقة التي كانت سائدة في العالم في صدر الإسلام، كما بيَّنه العلامة محمد رشيد رضا في قوله: "التقاليد المتَّبَعة في المُلْك أن المَلِك فوق الرعية فلا يتطاولون إلى مقامه الأعلى ليسألوا عما فعل، وهذا شيء أبطله الإسلام بجعْله إمام المسلمين كواحد منهم في جميع أحكام الشريعة...، وكان المسلمون يراجعون الخلفاء الراشدين ويردون عليهم أقوالهم وآراءهم، فيرجعون إلى الصواب إذا ظهر لهم أنهم كانوا مخطئين". (رشيد رضا، الخلافة، 147-148).
لكن المسلمين -للأسف الشديد- أضاعوا في جل مراحل تاريخهم مبدأ الرد إلى الله والرسول، بهذا المعنى الدستوري الذي يضمن المساواة بين الحاكم والمحكوم أمام القانون. فقلما وُجد في التاريخ الإسلامي حاكم يضع نفسه مع المحكومين على قدم المساواة أمام حكم الشرع، خصوصا إذا تعلق الأمر بأمور السياسة والحكم.
صحيح أنه وُجد حكام كثرٌ في التاريخ الإسلامي أقاموا شيئا من العدل بين رعاياهم، وكفُّوهم عن التظالم فيما بينهم بشكل عام، لكن أولئك الحكام استثنوا أنفسهم من معايير العدل التي طبقوها على رعيتهم. وقد لاحظ ابن خلدون ذلك، فأشار إلى أن الرعايا "مكبوحون بحكمة القهر والسلطان عن التظالم، إلا إذا كان من الحاكم نفسه". (ابن خلدون، المقدمة، 159).
بل إن استئثار الحاكم بالظلم -مع منعه الرعية من التظالم- أصبح هو المثل الأعلى في ثقافة المسلمين أحيانا. ولذلك "قال الأعرابي الوافد على عبد الملك لما سأله عن الحجاج -وأراد الثناء عليه عنده بحسن السياسة والعمران- فقال: تركتُه يظلِم وحدَه". (ابن خلدون، المقدمة، 188). وكأن ظلم الحاكم للمحكومين مستثنىً من تحريم الظلم في دين الإسلام!!
وما أبْعدَ هذا التصور الذي يجعل السلطان فوق القانون من المثال الذي سنَّه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث المساواة التامة بين الحاكم والمحكوم أمام الشرع، حتى شرع لعامة الناس الانتصاف من حكامهم والاقتصاص منهم.
فالمساواة أمام القانون بين القوي والضعيف، وبين الحاكم والمحكوم هي التحدي الأكبر في السياسة. ومن غير هذه المساواة يُذعن الحق للقوة، وتضيع كل القيم السياسية، ويجعل الطغاة إرادتهم قانونا. وقد جعل الإسلام مسؤولية الحاكم مضاعفة، فهو مسؤول أمام الله في الآخرة، ومسؤول أمام الناس في الدنيا.
ولا تلغي أيٌّ من المسؤوليتيْن الأخرى: فلا مسؤولية الحاكم أمام الله في الآخرة تلغي مسؤوليته أمام الناس في الدنيا وقد استأمنوه على مصالحهم وشأنهم العام، ولا مسؤوليته أمام الناس ومحاسبتهم له في الدنيا تلغي حسابه الأخروي بين يدي الله. وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسؤولية المضاعفة، فقال: "إن الخلق عباد الله، والولاة نُوَّاب الله على عباده، وهمْ وكلاءُ العباد على نفوسهم". (ابن تيمية، السياسة الشرعية، 12).
أما القيمة الثانية من أمهات القيم السياسية التي نحتاج التذكير بها اليوم -لما رأيناه من انسياق أعمى مع أوامر السلطة في هذه الأيام، حتى وإن خالفت المعلوم بالضرورة من دين الإسلام- فهي مبدأ "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". فللسلطة الشرعية حق الطاعة على الناس في كل ما يحقق مصلحة عامة، ولا يناقض أحكام الشرع وبنود العقد بين الطرفين.
والطاعة هي الشق الثاني من العقد السياسي بين الحاكم والمحكوم بعد الأمانة والعدل. فقد رأينا في آيتيْ الأمراء في سورة النساء كيف أمر القرآن الكريم الحكام بأداء الأمانة والحكم بالعدل، ثم أمر الرعية بطاعة السلطة الشرعية، تأكيدا على تلك المعادلة ذات الشقين، التي تجمع بين واجبات الحاكم وواجبات المحكوم.
ولا تكون الطاعة واجبة إلا لمن كانت بيعته شرعية بشروطها الشرعية. وأهم تلك الشروط هو أن تكون البيعة اختيارية، ليست فيها شبهة إكراه. وهذا هو مدلول الحديث النبوي: "من بايع إماما فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع". (صحيح مسلم، 3/1472)، فلا أوضح في شرط الاختيار في البيعة من تعبير إعطاء "صفقة اليد" و"ثمرة القلب".
وفي ربط الطاعة بأداء الأمانة والحكم بالعدل في آيتيْ الأمراء دلالة صريحة على أن متولِّي السلطة بغير رضا المحكومين لا طاعة له، إذ هو يتصرف خارجَ مفهوم الأمانة، وداخلَ مفهوم الغصْب في الشريعة الإسلامية. ولعل الزمخشري كان أبلغ المفسرين تعبيرا عن هذا المعنى في شرحه لآيتيْ الأمانة والطاعة، إذ وصف حكام الجور بأنهم "لصوص متغلِّبة" ورفَض أي إسباغ للشرعية عليهم، أو إلزام الناس بطاعتهم.
قال الزمخشري: "لما أَمَر (اللهُ) الولاةَ بأداء الأمانات إلى أهلها وأن يحكموا بالعدل، أَمَر الناس بأن يطيعوهم وينزلوا على قضاياهم. والمراد بأولي الأمر منكم أمراء الحق، لأن أمراء الجور اللهُ ورسولُه بريئان منهم، فلا يُعطَفون على الله ورسوله في وجوب الطاعة لهم. وإنما يُجمَع بين الله ورسوله والأمراء الموافقين لهما في إيثار العدل، واختيار الحق، والأمر بهما، والنهي عن أضدادهما، كالخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان... وكيف تلزم طاعة أمراء الجور وقد جمع الله الأمر بطاعة أولي الأمر بما لا يبقى معه شك، وهو أنْ أمَرَهم أولاً بأداء الأمانات، وبالعدل في الحكم، وأمرهم آخرا بالرجوع إلى الكتاب والسنة فيما أشكل. وأمراء الجور لا يؤدون أمانة، ولا يحكمون بعدل، ولا يرُدون شيئا إلى كتاب ولا إلى سنَّة، إنما يتبعون شهواتهم حيث ذهبت بهم، فهم منسلخون عن صفات الذين هم أولو الأمر عند الله ورسوله، وأحقُّ أسمائهم اللصوصُ المتغلبة". (الزمخشري، الكشاف، 1/524).
كما يدل ربط الطاعة بأداء الأمانة والحكم بالعدل أيضا على أن المتصرف في السلطة بغير أمانة وعدل -حتى وإن كان حاكما شرعيا- لا طاعة له، إذ هو ناقضٌ للعهد بينه وبين الأمة، عاصٍ لله تعالى في فعله. فالطاعة في الإسلام ليست طاعة مطلقة على النمط الإمبراطوري الذي يجعل إرادة الحاكم قانونا، بل هي "طاعة مستثناة" بتعبير الإمام الشافعي.
قال الشافعي في شرح آية الطاعة: "كل من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة، وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة. فلما دانت لرسول الله بالطاعة، لم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول الله. فأُمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمَّرهم رسول الله، لا طاعة مطلقة، بل طاعة مستثناة، فيما لهم وعليهم". (الشافعي، الرسالة، 1/79).
وقد تضافرت الأحاديث النبوية المقيِّدة لطاعة السلطة الشرعية بالتزام تلك السلطة بمقتضى الشريعة. وفي هذا المعنى ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في المعروف" (صحيح البخاري، 9/63. صحيح مسلم، 3/1469)، "لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف". (صحيح مسلم، 3/1469)، "من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه". (سنن ابن ماجه 2/956. وقال محققوه شعيب الأرنؤوط وآخرون: "حسن صحيح")، "لا طاعة لأحد في معصية الله". (مسند أحمد، 34/252. وقال محققوه شعيب الأرنؤوط وآخرون: "إسناده صحيح").
وأكد هذا المعنى الإمام الحسن البصري حين سأله والي العراق عمر بن هبيرة "عن الكتاب يَرِد عليه من سلطانه بما فيه مخالفة [للشرع]، هل له سعة في تقديم الطاعة له؟ فقال [الحسن]: الله أحقُّ أن تطيعه، ولا طاعة له في معصية الله. فاعرضْ كتابَ أمير المؤمنين على كتاب الله، فإن وجدتَه موافقاً له فخُذْ به، وإن وجدتَه مخالفاً فأبْعِدْه". (ابن الأزرق، بدائع السلك، 2/96).
وهكذا فإن الطاعة السياسية في الإسلام مقيَّدة بقيْدين اثنين: قيْدِ الشرْعية وقيد الشريعة. فلا طاعة لسلطة ليست نابعة من اختيار الناس، ولا طاعة فيما يخالف الشريعة حتى وإن كانت السلطة الآمرة به كاملة الشرعية السياسية.
لكن بعض فقهاء المسلمين أوغلوا في طريق الكبح والزجر، وصاغوا الرخصة المصلحية الظرفية بلغة العزيمة الشرعية الدائمة، وتورطوا -بحسن نية- في تشريع الاستبداد والقهر، ومنحوا السلطة غير الشرعية حقوق السلطة الشرعية من طاعة ونصح ونصرة. وجاءت الطامة الكبرى في طاعتهم للسلطة غير الشرعية طاعة مطلقة، حتى فيما هو معصية بواحٌ لله عز وجل، كما نراه أمام أعيننا هذه الأيام.
إن ما على المسلم اليوم إدراكه بوضوح هو أن قيمة الفقيه أو الداعية ليست في علمه الشرعي بل في موقفه الشرعي، فكم من مستشرق ضليع في الفقه الإسلامي والتاريخ الإسلامي سلخ حياته في حرب على الإسلام.
والرأي في أوقات الصخب والتدليس والتباس المواقف أن يستفتي المسلم قلبه، اتباعا للحديث النبوي الآمر بذلك، ويبتعد عن المواقف غير الشرعية التي قد يتبناها بعض حملة العلم الشرعي خوفا، أو طمعا، أو اتباعا للهوى، أو محاباة للسلاطين. ولعل أبلغ نصيحة في هذا المضمار هي نصيحة محمد إقبال:
تمعّنْ بقلبك واستفتــــه ** ولا تسأل الشيخَ عن شانـهِ
خلا حَرَمُ الله من أهلـــهِ ** فكن أنت جذوة أركـانــــــهِ
فقلب المؤمن الصادق الباحث عن الحق أمينٌ لا يخون، وفطرته المتجردة من الهوى والخوف والطمع ميزانٌ لا يكذب، وهما أوْلى بالاتِّباع في أوقات الزيف والالتباس من أيِّ إمام، ولو كان إمام الحرم المكي، وأصدقُ فراسة من أي شيخ، ولو كان من آل الشيخ.