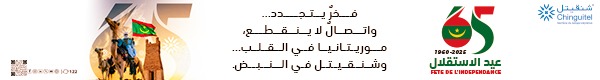بعد انقضاء 20 يوما من شهر ديسمبر2001، أغمض شاعر "الزنوجة" عينيه إلى الأبد، وفاضت تلك الروح التي طالما عدّها المؤرخون ملهما متألقا لفكر الزنوجة، ولانعتاق الإنسان الأفريقي.
وبوفاته عن 95 سنة ربيعا أفريقيا، أنهى ليوبولد سيدار سنغور رحلته مع المداد والسياسة، ليأوي بعد قداس كاثوليكي إلى ضريح في العاصمة دكار التي احتضنته طالبا وسياسيا ورئيسا ذا قبضة قوية وتأثير مكين، ليتحول -لاحقا- بيته في العاصمة السنغالية دكار إلى متحف يتضمن كثيرا مما ترك الراحل من آثار ومقتنيات.
تقول الروايات إن سنغور ولد لأسرة ثرية من قومية السيرير التي تتوزعها الأديان السائدة في السنغال من إسلام ومسيحية ووثنية، لكنه سرعان ما نفض رداء الترف المخملي، وتحول إلى مناضل من أجل استقلال بلاده.
أبصر سنغور نور الحياة عام 1906، في جوال فاجوت وهي قرية قريبة من العاصمة السنغالية دكار، ونشأ في أسرة متدينة ذات ارتباط شديد بالكنيسة الكاثوليكية، وتلقى تعليمه الأول في سن مبكرة من حياته، وذلك في مدرسة دينية تابعة للبعثة الكاثوليكية في المنطقة.
ولم يصاحب دخوله إلى المدرسة كثيرا من الاحتفاء، إذ يشير في أحد كتبه إلى أن أباه كان يضربه ويقرّعه على تسكّعه الدائم فيقول "وانتهى كي يعاقبني ويربيني بإرسالي إلى مدرسة البيض، رغم معارضة أمي التي رأت أن السابعة سن مبكرة للتعليم".
أبرز منظري الزنوجة وحامل لوائها
لقد كان أبرز عنصر في حياة الرجل وتكوينه هو تحويله "السواد" الأفريقي من "منقصة" يدوسها الإنسان الأبيض الذي جاس خلال الديار الأفريقية مستعمرا، إلى ميدان خصب للاعتزاز بالهوية والانتماء، وإلى مجال واسع لتشكيل الذات الأفريقية المفعمة بآثار الطوطم، وأنغام الموسيقى الصاخبة، وابتهاج الألوان الطينية المزركشة، وأغاريد الفلاحين، وأهازيج المقاتلين الأفارقة الفارعي الطول المفتولي العضلات.
ولأن الرجل لم يكن ينتمي إلى هذا الصنف الأخير، فقد كان مقاتلا من خلال الريشة والمداد والألق الشعري، وجعل من اللغة الفرنسية لسان البيان الأفريقي.
وقد أخذت الفرنسية جزءا أساسيا من هوية الرجل وتكوينه، بل لم يكن أمامه من مصدر للتكوين سواها، لكنه نال منها المستوى العالي الذي أهّله لأن يكون أحد مجتهدي لسان بلاد الغال، وذلك عندما أدخله والده مدرسة ابتدائية مسيحية، قبل أن ينتقل إلى ثانوية الأب ليبرمان في العاصمة دكار حيث نال الثانوية العامة سنة 1928 وهو في سن الثانية والعشرين من عمره.
وقد احتاج الشاعر الأفريقي المهووس بهموم بلاده 10 سنوات أخرى ليكون أول أفريقي يتخرج في السوربون، ولعله أيضا أول أفريقي ينال شهادة الدراسات المعمقة في تخصص الأدب والنحو الفرنسيين.
وإذا كانت الهوية الزنجية قد خرجت باكرا من أصلها اللاتيني، وترافق صعود تيارها مع موجة الاستقلال في أفريقيا؛ فإن أوارها الأول قد اشتعل في نيويورك بالولايات المتحدة، ثم امتد إلى فرنسا ذات التاريخ العريق في قتل الهوية الأفريقية وفي تصفيد العنفوان الثقافي للإنسان الأسود
وقد كانت مجلة "الطالب الأسود"، التي أسسها سنغور مع أستاذه الشاعر المارتينيكي إيمي سيزار (الذي كان أول من اشتق مصطلح أو تعبير الزنوجة)، بمنزلة صيحة احتجاجية ثورية، وكانت العنوان الإعلامي الأول للزنوجة التي تشير إلى الوعي بقضية الزنوج في أبعادها السياسية والثقافية والفكرية.
وتمكنت تلك المجلة من استقطاب عدد معتبر من كتاب وأدباء المداد الأسمر، وعبر صفحاتها كان سنغور ورفاقه ينشرون رؤيتهم الجديدة حول الخصوصية السوداء وما تحمله من قيم تتجسد في أنماط الحياة والثقافات الأفريقية، وضرورة القبول بهذه القيم وما تستبطنه من اختلافات وتباينات عن الآخر.
وبالإضافة إلى ذلك، أخذ سنغور على نفسه تقريب الزنوجة لكي تدخل في أهازيج الرعاة الأفارقة، وتهتز الأرض بها تحت أقدام المصارعين الأفارقة، وتغرسها النساء في الضفائر المجعدة.
الشاعر الأسير.. تحت ثلج النازية ورصاصها
رغم روح الزنوجة الهادرة في دم سنغور، فإنه وجد نفسه مجددا يقتفي خطى القوافل الأفريقية السمراء التي تعبر على دموعها ودمائها الحضارة الغربية المعاصرة، ليجد نفسه في سنة 1940 جنديا يخوض المعارك تحت راية فرنسا وفي مواجهة ألمانيا النازية، ليجد نفسه بعد ذلك أسيرا على مدى عامين، وهي المأساة التي خلّدها في بعض قصائده الذائعة.
ومن الأسر إلى النضال السياسي خرج سنغور مع نهاية الحرب العالمية، لينطلق كفرس أفريقي جامح في سعي إلى إرسال عدالة -لا أرضية لها في ذلك الحين- بين البيض والسود. ومن بوابة تلك المبادئ والأصوات النضالية كما يقول البعض، أو بفعل علاقته الوثيقة بالمستعمر السابق، دخل البرلمان الفرنسي نائبا عن السنغال سنة 1946، وهو المنصب الذي حافظ عليه في دورات 1951، و1956، وبدا أن فرنسا تهيئ الرجل لتسلّم مقعد الحاكم الفرنسي "في باريس الصغيرة"؛ ذلك اللقب الضخم الذي كان الأفارقة يطلقونه على دكار، درة المدائن الأفريقية.
المسيحي المستبد الذي انتخبه المسلمون
مع رياح الاستقلال في الفضاء الأفريقي أواخر خمسينيات القرن الماضي وبداية ستينياته، أصبح السياسي السنغالي الشهير لمين غي رئيسا للجمعية الوطنية السنغالية. وتمهيدا للانتقال إلى نظام رئاسي، دعا غي -الذي كان الرجل السياسي الأهم في السنغال- سنغور إلى العودة إلى بلاده لكي تستفيد من خبرته، ولم تكن تلك الدعوة إلا بداية النهاية لطموح ومشروع لمين غي، والمصعد الأكثر سرعة لسنغور لكي يتربع على الحكم في السنغال، بعد أن نال ثقة الأكثرية المسلمة التي دعمتها على حساب ابنها لمين غي.
عمل في فيلم "سنغور.. الرئيس الشاعر" (الجزيرة)
ومن المفارقات اللافتة أن سنغور تغلب على منافسه لمين غي ليس فقط بسبب الدعم الفرنسي القوي، وإنما بسبب دعم القيادات الدينية التقليدية، وذلك على الرغم من أن غي كان مسلما متدينا، بينما كان سنغور ينتمي لأقليتين: دينية (المسيحية الكاثوليكية)، وإثنية (السيرير).
وبعد أن تجاوز معركة انتخابه رئيسا للبلاد، بتوليه رسميا رئاسة السنغال في أكتوبر/تشرين الأول 1960، جاء تحدي البقاء والاستمرار؛ فاختار سنغور طريقا سياسيا قويا في تثبيت أركان حكمه عبر علمانية حمراء وقوية، وكان قلمه هو مبدع النشيد الوطني السنغالي الذي حمل عنوانا أسطوريا هو "الأسد الأحمر".
كان اللون الأحمر شعار الشيوعية، والكتاب الأحمر إنجيل الاشتراكيين في حقبة الستينيات، وحاول سنغور أن يحول المبادئ الاشتراكية إلى فلسفة في الحكم، ولم يكتف بجعلها عنوان رؤيته لأفريقيا الموحدة، أو بالأحرى أفريقيا الاشتراكية الفرنكفونية.
سلم الرئيس سنغور كرسي الحكم إلى خليفته عبدو ضيوف الذي تربى على عينه، وتدرج بسرعة كبيرة في المناصب والمواقع السامية، حتى وصفه معلمه وأستاذه (سنغور) ذات مرة بأنه يملك محركا بقوة 100 حصان من نوع "سنغور".
من تقرير للجزيرة